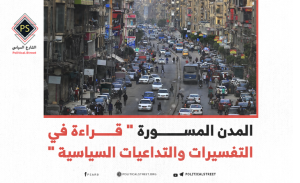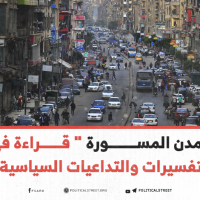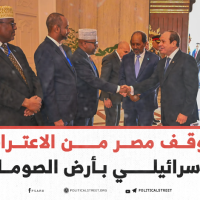في مشهد يعكس حجم التراجع الإقليمي لمصر، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في 3 يوليو 2025، اكتمال بناء سد النهضة الكبير، موجّهًا دعوة رسمية إلى مصر والسودان لحضور حفل الافتتاح المزمع في سبتمبر المقبل. هذه الخطوة – رغم ما تحمله ظاهريًا من طابع دبلوماسي – تأتي كذروة مسار سياسي مائي فاشل، كرّسته الإدارة المصرية الحالية منذ توقيع “اتفاق المبادئ” الكارثي في 2015، الذي منح أديس أبابا للمرة الأولى اعترافًا قانونيًا بحقها في بناء السد دون أي ضمانات مُلزمة لحقوق مصر التاريخية في مياه النيل. لقد تحوّلت مصر من دولة مقررة إلى طرف مُستدرَج لحفلاتٍ تدشينية تأتي تتويجًا لهزيمتها الاستراتيجية في ملفٍ وجودي.
من توقيع الخراب إلى لحظة الإذلال: كيف فتحت السلطة المصرية الباب للسد؟
يُجمع أغلب خبراء المياه والقانون الدولي أن الجريمة السياسية الكبرى لم تكن في بناء السد، بل في منح الشرعية له عبر توقيع اتفاق 2015. هذا الاتفاق – الذي وقّعه السيسي شخصيًا – أسقط صفة “الاعتداء غير المشروع” عن السد، واعتبره مشروعًا قوميًا إثيوبيًا يستحق الاعتراف والتعاون، دون اشتراط توقيع اتفاق ملزم بشأن سنوات الملء أو قواعد التشغيل. بل إن أخطر بنوده كان التعهد بـ”عدم الإضرار”، وهو بند غامض يسمح بتأويلات فضفاضة، ويضع العبء الإثباتي على مصر، لا على إثيوبيا. وبذلك، انتقل الملف من كونه خرقًا إثيوبيًا لحقوق مصر، إلى كونه خلافًا فنيًا قابلًا للحل، وهو ما استغلته أديس أبابا لاحقًا في جميع المحافل الدولية، لتبدو “متعاونة”، في حين ظهرت القاهرة بمظهر الطرف المراوغ.
ولم تكن كارثة الاتفاق سوى تتويج لمسار أوسع من سوء الإدارة. فمنذ 2013، أفرغ النظام المصري المؤسسات الفنية من الكفاءات المستقلة، وأحلّ محلها دوائر أمنية ومكاتب ملحقة بالرئاسة، ما أدى إلى تهميش وزارة الري وتفريغ الهيئة العامة لمشروعات المياه من دورها. وتمت هندسة الملف سياسيًا لا علميًا، على نحو سمح بتوقيع اتفاق بلا دراسات، وبلا مداولات عامة، وبلا مساءلة برلمانية. لقد قرّر الجنرال توقيع الاتفاق كما يُوقّع أمرًا عسكريًا، ففتح بذلك الباب لحصار مصر مائيًا دون طلقة واحدة.
الدعوة الإثيوبية: رسالة إذلال أكثر منها دبلوماسية
دعوة آبي أحمد لمصر والسودان لحضور حفل الافتتاح ليست إلا تكتيكًا لإحكام قفل “مشروع السد” سياسيًا، وتثبيت الهيمنة الإثيوبية عبر مشهد احتفالي يُصور أديس أبابا كقوة تنموية صاعدة، والقاهرة كدولة فاشلة تُستدرج لتصفق لمن حاصرها. الخطاب الإثيوبي – المتكرر حول “فرص التنمية المشتركة” – لا يمكن فصله عن الواقع: أربعة ملءات تمت دون اتفاق، رفض متكرر لتقديم بيانات التشغيل، تقارير تؤكد التخزين في فترات الجفاف، وتعنت في إدماج أي آلية إنذار مبكر تُفيد مصر أو السودان. بل إن أديس أبابا تمادت في التهديد بإدارة مياه النيل باعتبارها “سلعة سيادية”، ملوّحة بفكرة تسعير المياه أو بيع الكهرباء بشرط الخضوع السياسي، وكل هذا بفضل توقيع السلطة المصرية على اتفاق منحها الأرضية القانونية.
انهيار المنظومة المائية والزراعية: نتائج حتمية لفشل سياسي
الخطر المائي الذي يتهدد مصر لم يعد سيناريو مستقبليًا بل واقعًا معاشًا. فبحسب تقرير للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء (2024)، تراجعت حصة المواطن المصري من المياه إلى 540 مترًا مكعبًا سنويًا، مع توقع نزولها تحت خط الفقر المائي (500 م³) خلال عامين. وتشير بيانات رسمية إلى انخفاض منسوب بحيرة ناصر بمقدار 11 مترًا منذ بدء أول ملء لسد النهضة، ما أثّر مباشرة على كفاءة السد العالي وأدى إلى تقليص عدد أيام الري في محافظات الدلتا. كما تكشف تقارير صادرة عن وزارة الزراعة عن فقدان أكثر من 800 ألف فدان من المساحة المزروعة، بسبب نقص مياه الري، وارتفاع نسبة الملوحة في شمال الدلتا.
وعوضًا عن معالجة الأزمة بخطط استراتيجية، لجأت الحكومة إلى مشاريع تحلية وصرف مكلفة، لا تُدار بشفافية، وممولة عبر قروض أجنبية، ما زاد من أعباء الدين العام. ومن المفارقات أن النظام العسكري الذي برر توقيعه الاتفاق بـ”ضمان السلم الإقليمي” يجد نفسه اليوم في مأزق تمويلي وأمني، مع ارتفاع تكلفة استيراد الغذاء، وانهيار قيمة الجنيه، وتنامي الغضب الشعبي في الأقاليم الزراعية.
السودان: المراقب المتضرر في مشهد التواطؤ الإقليمي
أما السودان، فقد دفع ثمناً مزدوجًا: التهميش المائي والانكشاف السياسي. فبعد أن غلبت عليه نغمة الحياد في بدايات الأزمة، فوجئ خلال الملء الأول والثاني بانخفاض مفاجئ في تصريف المياه، مما أدى إلى توقف محطات مياه الشرب في الخرطوم، وتدمير المحاصيل في النيل الأزرق. ولم تفلح محاولاته اللاحقة في فرض آلية لتبادل المعلومات، خاصة مع غياب سلطة مركزية موحدة بعد انقلاب 2021. وأصبح السودان اليوم في وضع تابع؛ يتحكم جاره الشرقي في تدفقات النيل، بينما تُفرَض عليه تبعات القرارات الإثيوبية دون أن يمتلك قدرة الرد أو التأثير.
الختام: حين تدفع الشعوب ثمن هندسة السلطة
إن اكتمال بناء سد النهضة لا يمثل فقط فشلًا تفاوضيًا أو هزيمة دبلوماسية، بل نتيجة حتمية لنظام انقلابي قام على تصفية الكفاءات، وتحويل ملفات الدولة إلى صفقات سياسية داخل غرف مغلقة. لقد أدارت السلطة المصرية أخطر ملف وجودي بعقل أمني، فوقّعت دون شروط، وتفاوضت دون أدوات، وأدارت الأزمة بمنطق التبرير لا الحل. واليوم، لا يمكن الحديث عن “خسارة معركة السد” دون تحميل النظام القائم المسؤولية السياسية والأخلاقية الكاملة. والمطلوب ليس مجرد نقد فني، بل مساءلة شاملة لمن منح الخصم مفاتيح النهر، ثم جاء يخطب في الناس عن الصمود.