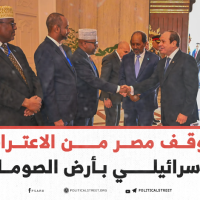تأمل جماعة الإخوان المسلمين أن يكون سقوط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية أمام منافسه الديمقراطي جوبايدن تدشينا لمرحلة جديدة تسهم في حدوث تغيير حقيقي بمصر والمنطقة العربية، وأن تتخلى الإدارة الأمريكية الجديدة عن النهج الذي اتسمت به إدارة ترامب اليمينية المتطرفة خلال السنوات الأربعة الماضية، من خلال دعم أنظمة الاستبداد العربي وليس فقط التغاضي عن انتهاك حقوق الإنسان بل تحريض هذه النظم على انتهاكها كيما تشاء بدعوى الحرب على ما يسمى بالإرهاب.
وفي هذا الشأن أصدرت الجماعة بيانا مع ظهور مؤشرات فوز بايدن، ثمنت فيه الجماعة فوز المرشح الديمقراطي ودعت الإدارة الأمريكية الجديدة المنتخبة إلى مراجعة سياسيات دعم ومساندة الدكتاتوريات، وما ترتكبه الأنظمة المستبدة حول العالم من جرائم وانتهاكات في حق الشعوب”. وتمنت الجماعة لـ”بايدن وللشعب الأمريكي ولشعوب العالم أجمع دوام العيش الكريم في ظل مبادئ الحرية والعدالة والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان”. وحذرت الجماعة إدارة بايدن من أن “أي سياسات يتم فيها تجاهل الشعوب وخياراتها الحرة والاكتفاء ببناء علاقاتها مع مؤسسات الاستبداد الحاكمة، ستكون اختيارا في غير محله، ووقوفا على الجانب الخاطئ من التاريخ”.[[1]]
ورغم أن السيد إبراهيم منير نائب المرشد العام للجماعة، توقع ــ في مداخلة على قناة «الجزيرة مباشر» ــ ألا يمارس الرئيس الأمريكي المنتخب ضغوطا على رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي من أجل الإفراج عن موقوفي الجماعة معللا ذلك بأن بايدن سيحتاج إلى وقت ليرتب نفسه؛ إلا أن منير لم يستبعد حدوث تغيير في المنطقة لأسباب وعوامل اقتصادية وتفشي جائحة كورونا، إضافة إلى حاجة المنطقة الملحة للهدوء وإعادة ترتيب وقد يكون من بينها مصر وما يتعلق بملف حقوق الإنسان.
وبسؤاله عن جدوى الرهان على إدارة بايدن، مع أن الانقلاب العسكري في مصر وما تلاه من مذابح وحشية جماعية وقع في ظل إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، حيث كان بايدن نائبا له، رجح منير ألا تكون سياسية “بايدن” مع مصر كآخر أيام وجوده كنائب للرئيس الأمريكي “باراك أوباما”. واستند منير فيما ذهب إليه إلى عدة أسباب: أولها، أن الوضع اختلف عما كان في منتصف 2013م، وهناك سنوات مضت والخارجية والإدارة الأمريكية راجعت ما يتم بمصر، ولن تكون سياسات بايدن كما مضى”. وثانيا، تأكيده أن الصورة عن الجماعة “تغيرت”، عما كانت من قبل لدى الإدارة الأمريكية، مشيرا إلى إتمام لقاءات سابقة مع مسئولين بالخارجية الأمريكية ومراكز بحث أمريكية لتوضيح ذلك. وأوضح أن الجماعة أجرت بالفعل لقاءات مع أعضاء بمجلس الشيوخ ونواب بالكونجرس، بما يكفي لتوضيح الصورة على حد تعبيره. متوقعا أن يكون هناك مزيد من التواصل بين الجماعة والإدارة الأمريكية الجديدة خلال الفترة المقبلة. وأن التقارير التي سيتطلع عليها بايدن وإدراته ستكشف أن ما وصل عن الجماعة ليس صحيحا. مطالبا الإدارة الأمريكية بأن “تعود لقيم الديمقراطية واحترام إرادة الشعوب”.[[2]]
«الصفقة التاريخية»
قبل الشروع في مناقشة مستقبل علاقة إدارة الرئيس جو بايدن بالحركات الإسلامية يتعين الإشارة أولا إلى ما كتبه الباحث الأمريكي، روبرت ساتلوف، قبل عقدين من الزمان والذي يشغل حاليا المدير التنفيذي لمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، حيث وضع تأطيرا لرؤية الإدارات الأمريكية للحركات الإسلامية ضمن منظور المصالح الأمريكية. وانتهى إلى أن (المصالح) هي المعيار الرئيس في تحديد موقف واشنطن من الإسلاميين إيجابا وسلبا في هذه الدولة أو تلك. وداخل هذا الإطار الذي يحتكم إلى معيار (المصالح) رجحت كفة الصقور أو التيار المتشدد في الأوساط الأمريكية على رؤية التيار التوافقي أو المعتدل؛ وبالتالي فإن منظور المصالح رجح كفة التحالف مع النظم العربية المستبدة في مواجهة القوى الإسلامية المتصاعدة؛ الأمر الذي أثر بشكل سلبي على الموقف من العملية الديمقراطية؛ فكان (البعبع) الإسلامي بمثابة الفزاعة لتكريس ما وصفها خبراء أمريكيون بــ«الصفقة التاريخية» بين الولايات المتحدة والأنظمة الاستبدادية في المنطقة.[[3]]
ظلت هذه المعادلة «الصفقة التاريخية» قائمة على هذا الأساس منذ ثمانينات القرن الماضي حتى وقعت أحداث 11 سبتمبر 2001م، حيث اتهمت مراكز التفكير والبحث الأمريكية هذه «الصفقة التاريخية» بالمسئولية عن الأحداث، وأن الدعم الذى تحظى به النظم العربية المستبدة من جانب أمريكا هو الذي أفضى إلى نمو حالة الغضب بين الشعوب العربية والإسلامية تجاه الولايات المتحدة الأمريكية. هذه المراجعة أفضت إلى تولد تصورات جديدة من بينها مبادرة كولن باول (وزير الخارجية الأميركي الأسبق في عهد بوش الابن) لنشر الديمقراطية في العالم العربي، وكانت ترجمة ذلك عملياً، في عهد المحافظين الجدد، من خلال احتلال العراق، بدعوى نشر الديمقراطية، وهو المشروع الذي أُزهق في مكانه، ما أدّى إلى ركودٍ كبير في هذه المدرسة الجديدة.
تحولات الربيع العربي
لكن الربيع العربي ردَّ الروح لهذه المراجعات الأمريكية ودعم الدعوات الشعبية التي تطالب بالتغيير، والتخلص من فوبيا البديل الإسلامي. وتخلت إدارة الرئيس باراك أوباما عن حلفاء عرب، على غير رغبة فريق واسع من إدارته؛ يدلل على ذلك ما كشفته تقارير الصحافة الأمريكية حول ضغوط المخضرمين في إدارة أوباما من أجل بقاء مبارك أثناء ثورة يناير وعدم الضغط عليه للتنحي، ومن مثال هؤلاء هيلاري كلينتون وجون كيري وجوبايدن الرئيس الفائز مؤخرا ضد ترامب، بينما كان مارس فريق الشباب في إدارة أوباما والذين كانوا يتمتعون بهامش من الإيمان بالديمقراطية ضغوطا على أوباما من أجل الانحياز لمطالب الشعب بالتغيير والديمقراطية، وتمكنوا من إقناعه بذلك، حتى خرج بخطابه الشهير الذي دعا فيه مبارك إلى التنحي فورا والآن؛ الأمر الذي كان له تأثير كبير ــ بلا شك ــ في الإطاحة بمبارك.
وأثناء الربيع العربي الذي لم يدم طويلا، برزت نقاشات معمقة في الأوساط الأميركية بشأن العلاقة مع الإسلاميين. وقد استضافت العاصمة واشنطن مؤتمراً غير مسبوق حينها للحركات الإسلامية في 2012، بدعوةٍ من مؤسّسة كارنيجي للسلام، وتخلّل المؤتمر حوار في الخارجية الأميركية مع قيادات إسلامية، ما كان يؤشّر إلى منعطفٍ جديدٍ في العلاقة بين الطرفين.
لكن مجموعة من الأحداث وقعت خلال تلك الفترة(حرب غزة 2012م وموقف الرئيس محمد مرسي الأخلاقي ورفضه للعدوان الإسرائيلي وإعلانه عن دعم غزة ــ مقتل السفير الأمريكي في ليبيا ــ تصاعد روح العداء لإسرائيل) كلها عوامل دفعت الإدارة الأمريكية إلى العودة إلى مربع التشدد تجاه الإسلاميين؛ إذ تعرضت أهم مصالح واشنطن للخطر وهي حماية أمن (إسرائيل) وضمان تفوقها على جميع البلاد العربية، وتحجيم المقاومة الفلسطينية وأي مقاومة للمشروع الأمريكي الإسرائيلي في المنطقة؛ إذ وجدت واشنطن في تكريس الديمقراطية في مصر والبلاد العربية سبيلا لسيطرة القوى الإسلامية على كثير من نظم الحكم؛ وبالتالي سيفضي ذلك إلى تحرير القرار الوطني في مصر والبلاد العربية من التبعية لواشنطن، وستعود للشعوب العربية سيادتها الفعلية على بلادها، وهذا بحسب مراكز بحث إسرائيلية وأمريكية، يمثل أكبر تهديد لمصالح أمريكا وإسرائيل في المنطقة. وبناء على هذه الأحداث تحرك جناح المخضرمين في إدارة أوباما(زيارة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري للقاهرة في مارس 2013م وغضبه من الرئيس مرسي خير مثال) مدعوما من مؤسسات أمريكية كالبنتاجون (علاقة السيسي بوزير الدفاع الأمريكي تشاك هيجل قبل الانقلاب ورعاية البتاجون لكل خطوات الانقلاب) والسي إي إيه والخارجية الأمريكية من أجل إجهاض الربيع العربي عبر منح الضوء الأخضر لإسرائيل ونظم الاستبداد العربي في الخليج من أجل توظيف نفوذها داخل الدولة العميقة في مصر من أجل وأد الربيع العربي واستئصال الإسلاميين. وهو ما جرى في مشهد انقلاب 3 يوليو 2013م، والذي كان أساس المؤامرة ولكن جرى التغطية عليه بحشود مدفوعة الأجر من أجنحة الدولة العميقة وفلول نظام مبارك والكنيسة في 30 يونيو 2013م والتي لم تستمر سوى يوم واحد تحت حماية الجيش والشرطة وجرى تضخيمها إعلاميا على نحو واسع؛ حتى تبدو وكأن المؤسسة العسكرية تحركت استجابة لثورة شعبية.
مع مجيء إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب (2016)، تعرّضت المدرسة التوافقية في الأوساط الأميركية لانتكاسة كبيرة، وأعاد الرئيس ترامب تجديد العلاقة مع الأنظمة العربية، بل ومضى خطواتٍ أبعد نحو شيطنة الإسلام السياسي وإقصائه، وتحالف مع المدرسة المتشدّدة التي تعتبر الإسلاميين عموماً راديكاليين، وجسراً إلى الإرهاب، يتوافقون في الأهداف، وإن اختلفوا في الأساليب، لا فرق بين سعد الدين العثماني (رئيس الوزراء المغربي الحالي وقيادي حزب العدالة والتنمية الإسلامي) وأبي بكر البغدادي زعيم تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).
النظم العربية وإدارة بايدن
مع فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن على الرئيس الجمهوري دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية نوفمبر 2020م؛ تعرض التحالف الأمريكي الإسرائيلي مع نظم الاستبداد العربي لهزة كبيرة؛ ليس خوفا من دعم إدارة بايدن للديمقرطية في المنطقة والتقارب مع الإسلاميين، ولكن لأن مخططات هذا التحالف لن تجد ذات الزخم والدعم القوى والرهيب الذي أبدته إدارة ترامب في دعم إسرائيل وتحالف الاستبداد العربي.
نعم، كشفت تصريحات سابقة لبايدن عن استنكاره للدعم اللا محدود من جانب ترامب للديكتاتوريين العرب، وأعلن بشكل واضح أن زمن الشيكات على بياض لدكتاتور ترامب المفضل (في إشارة إلى السيسي) سوف تتوقف. كما كشفت تصريحات سابقة لمسئولين في إدارة بايدن عن ذات التوجه؛ لكن ذلك لا يعني أن إدارة بايدن سوف تتخلى عن «الصفقة التاريخية» بين واشنطن ونظم الاستبداد العربي، لكنها قد تكون أكثر تشددا فيما يتعلق بملف الحريات وحقوق الإنسان، وربط المساعدات الأمريكية لنظام السيسي بتحسن ما في ملف حقوق الإنسان.
وأمام هذه التحولات، سعى تحالف الثورات المضادة نحو تذكير بايدن وإدارته المقبلة بمرتكزات العلاقات الأمريكية والصفقة التاريخية بين الطرفين، وتحركت في 3 اتجاهات:
الأول، هو الانفتاح الواسع من تحالف الثورات المضادة نحو عقد اتفاقات تطبيع مع “إسرائيل”، حيث بدأته الإمارات والبحرين، والسعودية في الطريق بعدما أبدى ولي العهد محمد بن سلمان حماسته لهذه الخطوة، كما قام هذا التحالف (السعودية ــ الإمارات) بالضغط على عسكر السودان لعقد اتفاق تطبيع مماثل كما كان للسعودية والإمارات دور ملموس في اتفاق التطبيع المغربي مؤخرا. بهذه الخطوة يؤكد تحالف الثورات المضادة أنه يفهم المصالح الأمريكية جيدا في المنطقة؛ وأن “إسرائيل” باتت هي مفتاح هذه المصالح وأساسها بعدما فقد النفط العربي مكانته بعد تراجع الطلب عليه مع اكتشافات النفقط الصخري في الولايات المتحدة الأمريكية، وأن هذه النظم هي من تتكفل في حقيقة الأمر بحماية المصالح الأمريكية ليس فقط بحماية أمن الكيان الصهيوني، بل من خلال إدماجه في تحالف واسع (عربي ــ إسرائيلي) ما يمثل ليس فقط قبولا باغتصاب “إسرائيل” لفلسطين بل تكريسا لهذا الاحتلال وضمان بقائه واستمرار تفوقه على الجميع.
الثاني، هو شن هجوم واسع على جماعة الإخوان المسلمين، وإصدار بيانات من مؤسسات دينية رسمية كبرى (هيئة كبار العلماء السعودية ـ الإفتاء الإماراتية ــ الأزهر) تعيد التذكير بأن جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية لا تمثل الإسلام وأن هذه النظم تجدد الالتزام بذلك على نحو واضح. وهي البيانات التي مثلت رسالة لا تخفى دلالتها لإدارة بايدن، بأن مصالح أمريكا التي ترتكز على «الصفقة التاريخية» ستكون محل تهديد ما لم تلتزم الإدارة الديمقراطية المقبلة بعدم الضغط على نظم الاستبداد العربي في ملف الديمقراطية، وتجنب التقارب مع الإخوان أو منحهم فرصة العودة من جديد؛ لأن صعود الإخوان هو أكبر تهديد لأهم مصالح أمريكا في المنطقة (إسرائيل). وتزامن مع هذه الخطوة شن حملة اعتقالات موسعة بحق من تبقى من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين في مصر، ومن اعتقلوا قبل ذلك وجرى إخلاء سبيلهم، حيث جرى استدعاء المئات منهم خلال الأسابيع القليلة الماضية، في دلالة غير خافية تتعلق بزاويتين: الأولى هي مخاوف النظام العسكري من ذكرى ثورة يناير. والثانية، هي توجيه رسالة لإدارة بايدن بأن النظام لن يتهاون بحق الجماعة ليس من باب مصالح النظام فقط؛ بل لحماية مصالح أمريكا وإسرائيل التي يضمنها بقاء هذه النظم المستبدة. وهي الحملة التي شملت أيضا رجال أعمال في تأكيد على التزام النظام بالحرب على الإسلاميين المقربين منهم والمتعاطفين معهم والذين يشكلون خطرا على المشروع الإسرائيلي في المنطقة.
الثالث، هو تحريض أجنحة داخل الحزب الجمهوري من أجل تقديم مشروع قانون للكونجرس من أجل تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية ووضعها على لوائح الإرهاب الأمريكية مع ما يترتب على ذلك من حصار للجماعة وقادتها وأنشطتها ومؤسساتها في معظم بلاد العالم. وقبل مغادرة ترامب البيت الأبيض تقدم أربعة أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي يوم 3 ديسمبر 2020م، هم تيد كروز، وجيم إنهوف، ووبات روبرتس، ورون جونسون، بمشروع القانون الذي لم يحقق الهدف منه لاعتبارات كثيرة، أهمها عدم وجود أدلة مادية على أن جماعة الإخوان تمارس الإرهاب أوتستهدف مواطنين أمريكيين بالعنف، إضافة إلى أن نصوص القانون الأمريكي تمنع ذلك بحسب نص الفقرة 1182 من قانون الإدراج التي اشترطت أن يكون (للتنظيم القدرة والنية للانخراط بأعمال إرهابية، وأن هذه الأنشطة تهدد الأمن القومي الأمريكي أو المواطنين الأمريكيين”). وجرى تحذير إدارة ترامب والجمهوريين من خلال الإعلام الأمريكي والمنظمات الحقوقية من أن تجاوز البعد القانوني في هذه المسألة، قد يكلف إدارة ترامب صراعا قضائيا أمام المحاكم الأمريكية لن يكون في صالحها؛ وبالتالي سيمثل إلغاء قرار إدارة ترامب من جانب القضاء الأمريكي انتصارا مدويا للجماعة. على غرار ما جرى في التحقيقات البريطانية التي جرت بضغوط خليجية وانتهت إلى تبرئة الجماعة من تهمة العنف والإرهاب.
مقاربة بايدن تجاه الإسلاميين
بلا شك فإن تداعيات «الصفقة التاريخية» بين الولايات المتحدة ونظم الاستبداد العربي انعكست بشكل كبير على المنطقة التي ظلت ولا تزال محرومة من الديمقراطية الحقيقية، وحتى عندما انتفضت الشعوب لانتزاع حقها في الديمقراطية وتحرير إرداتها المستقلة جرى التآمر على الربيع العربي على النحو الذي عاينه الجميع بتواطؤ واسع من الولايات المتحدة الأمريكية وفي ظل إدارة ديمقراطية (إدارة باراك أوباما 2008/2016م)؛ ثم جاءت إدارة ترامب لتنتقل من مربع التواطؤ والصمت على المذابح التي يتعرض لها الإسلاميون باعتبارهم الفريق الديمقراطي أمام النظم العربية المستبدة، إلى التحريض والحرب السافرة على الإسلاميين وقمع كل الدعوات المطالبة بالديمقراطية بدعوى الحرب على الإرهاب. وعادت فزاعة الإسلاميين لتتصدر مبررات النظم المستبدة والإدارة الأمريكية للالتفاف على مطالب الشعوب العربية نحو الديمقراطية.
ومع اقتراب عهد الرئيس الجديد جو بايدن، الذي سيتولى الحكم فعليا في 20 يناير المقبل “2021”م سيعود السؤال يطرح عن العلاقة مع الإسلاميين، وهل ستبقى معادلة ترامب قائمة، أم هنالك مقاربة جديدة ستخفف من الضغوط الإقليمية والمحلية التي يتعرّض لها الإسلاميون؟
دعونا أولا نشير إلى أن واشنطن في عهد بايدن لن تنظر إلى الحركات الإسلامية نظرة عامة وحكما مطلقا، بل يمكن تصنيف الإسلاميين إلى ثلاثة أنواع:
- الأول، هي الحركات الراديكالية التي ترى الديمقراطية كفرا، وتسعى إلى قهر الآخرين وإجبارهم على الانصياع لرؤاها بالعنف والسيف؛ كما يفعل تنظيم داعش وبدرجة أقل تنظيم القاعدة.
- الثاني، هو فريق من الإسلاميين أنشأتهم السلطة من أجل إضفاء مسحة من الشرعية الدينية على سياساتها وممارساتها كالتيار الجامي المدخلي، والحركات الصوفية، والمؤسسات الدينية الرسمية التي تتبنى توجهات السلطة وتدافع عن خياراتها مهما كانت بالغة الشذوذ والانحراف، ومهما كانت متصادمة مع نصوص الشرع وأحكامه.
- الثالث، هي الحركات الإسلامية الحركية المعتدلة التي تؤمن بالديمقراطية والتداول السلمي للسلطة وتشارك في الانتفاضات الشعبية التي تطالب بالحرية والديمقراطية باعتبارها قيم لا تتصادم في جوهرها مع الإسلام. وعلى رأس هذه الحركات جماعة الإخوان المسلمين ومن يؤمنون بأفكارها.
الفريق الأول وهي الحركات الراديكالية (داعش ــ القاعدة) تشن عليهم واشنطن وحلفاؤها حربا ضارية وتلاحقهم أينما حلوا. أما الفريق الثاني، وهي التيارات الدينية التي أنشأتها السلطة فتحظى بدعم أمريكي لدورها في صناعة ما يسمى بـ«الإسلام البديل»، حيث تدعم واشنطن نظم الاستبداد العربي في مساعيها نحو بناء مقاربة ثيولوجية للإسلام ذاته؛ وهي المقاربة التي تستهدف إعادة تأويل الإسلام بما ينسجم مع المصالح الأمريكية، ويشرعن دمج “إسرائيل” في المنطقة من خلال خلق مسوغات شرعية واهية ومزيفة تبيح للحكومات التطبيع مع الاحتلال والقبول باغتصاب فلسطين وقهر شعبها. وفي سبيل تحقيق هذا الهدف أنشأت الإمارات والسعودية تيارات ومؤسسات وجرى توظيف شيوخ ودعاة بسيف الترغيب والترهيب لخلق تيار واسع من المؤسسات الدينية الرسمية (كبار العلماء السعودية ــ الإفتاء الإماراتية ـ الأزهر) والطرق الصوفية والتيارات السلفية (الجامية المدخلية) التي جرى صناعتها في غرف المخابرات ومنحها امتيازات واسعة في المؤسسات الإعلامية والتعليمية والمجال العام من أجل تطويع النصوص الدينية لخدمة أجندة الاستبداد العربي عبر تأويلها تأويلا متعسفا يفرغها من معانيها وتحميلها تفسيرات وتأويلات بالغة الشذوذ والانحراف.
سياسيات واشنطن تجاه هذين التيارين واضحة، الحرب للراديكاليين، والدعم للإسلاميين السلطويين. لكن المشكلة في كيفية التعامل مع الفريق الثالث الذي يضع واشنطن في ورطة كبيرة؛ فهذا الفريق لا يستخدم العنف والإرهاب، بل يؤمن بالديمقراطية والأدوات السلمية في التغيير، وله تجارب عديدة حاز فيها ثقة الجماهير في كثير من البلاد العربية والإسلامية.
مشكلة واشنطن مع هذا التيار أمران: الأول، هو رفض هذا التيار للمشروع الصهيوني في المنطقة، بالتالي فإن هذا التيار يهدد فعليا أهم مصالح واشنطن في المنطقة وهي حماية أمن الكيان الصهيوني وضمان بقائه واستمراره، كما أن لهذا التيار دور كبير في رفض هرولة حكومات الاستبداد العربي نحو التطبيع مع الاحتلال. الثاني، أن هذا التيار يمثل تهديدا للصفقة التاريخية بين واشنطن والأنظمة العربية المستبدة، فهو تيار له شعبية جارفة وانتشار واسع؛ وهو بحق يعتير التيار الديمقراطي الحقيقي في المنطقة كلها. فالصراع في المنطقة بين النظم وهم دعاة طغيان واستبداد، وبين الشعوب وفي مقدمتها الإسلاميون، وهم دعاة للحرية والديمقراطية؛ وفي سبيل ذلك يتحملون كثيرا من الأذى والاضطهاد. فماذا عن علاقة واشنطن بهذا التيار الإسلامي الواسع؟ وهل يمكن أن تختلف مقاربات بايدن عن سياسات ترامب المحرضة ضد الإسلاميين بشكل سافر؟
مستقبل العلاقة بين واشنطن والإخوان
هناك تنبؤات وتوقعات وسيناريوهات متعددة حول مستقبل الإسلاميين وعلى رأسهم جماعة الإخوان المسلمين بإدارة بايدن المقبلة، وثمة من يرجحون أن تكون مقاربة بايدن مختلفة بشكل جذري عن مقاربة الرئيس الخاسر دونالد ترامب. لكن هناك من يستبعدون ذلك؛ استنادا إلى أن موقف الولايات المتحدة الأمريكية من الإسلاميين عموما والإخوان على وجه الخصوص، تقوم على تصورات وثوابت براجماتية اتساقا مع مرتكزات «الصفقة التاريخية» التي تضمن حماية المصالح الأمريكية في المنطقة (إسرائيل ــ تحجيم الحركات الإسلامية باسم الحرب على الإرهاب ـــ منع أي تحول ديمقراطي ـ النفط ــ حرية الحركة للأساطيل الأمريكية في قناة السويس والممرات المائية العربية ــ قواعد عسكرية ــ تحالفات عسكرية تسمح لواشنطن باستخدام جميع القواعد العسكرية العربية ــ انصياع تام للتوجهات الأمريكية)، وذلك مقابل بقاء الحكام على عروشهم والتغاضي عن انتهاكاتهم المروعة لحقوق الإنسان؛ وبالتالي فإن كلاهما (بايدن ــ ترمب) يعتمد على رؤية مشتركة تجاه الإسلاميين تختلف باختلاف الفروق الفردية بشأن شخص الرئيس وإدارته لكنها لا تنقلب على هذه الرؤية التي صاغتها مراكز البحث ومؤسسات صناعة القرار داخل الولايات المتحدة منذ عقود. فمحددات الرؤية الأمريكية للإسلام السياسي ملتبسة وذات طبيعة براجماتية فجة، محددة في إطار سياساتها في الشرق الأوسط الملتزمة بدعم الأنظمة الاستبدادية في إطار عقيدة الاستقرار، والحيلولة دون انتشار وتعاظم نفوذ الإسلاميين والقوى الثورية التي يمكن أن تهدد أمن المشروع الصهيوني في المنطقة. وبالتالي لا يخرج بايدن عن أطر السياسة الأمريكية التقليدية في الشرق الأوسط، التي تتحدد بمكافحة الإرهاب، وضمان أمن إسرائيل. ويقع موضوع الإسلام السياسي في سياق رؤية يمينية شعبوية قادها ترامب بمنح الاستبدادية حرية مطلقة بالتعامل مع الإسلام السياسي، في مقابل رؤية واقعية لبايدن تقيّد الاستبدادية بهامش من بعض قيم الديمقراطية والليبرالية.[[4]]
وبحسب مراقبين، لا توجد نظرية جاهزة لدى الإدارة الأميركية، لكن أغلب الظن أنّ هنالك محدّدات جديدة مختلفة ستتصاعد مع الإدارة الجديدة، ستتوقف معها الأجندة الأميركية المندفعة ضد التيار الإسلامي عموماً، وضد الموقف الحادّ منه، لكن الأجندة الإقليمية والمحلية في دولٍ كثيرة ستبقى قائمة، ما يولّد تساؤلاً آخر: إلى أي مدىً ستذهب الإدارة الأميركية الجديدة للحدّ من هذه الأجندة الإقليمية وفرملتها، وهي التي كان الرئيس ترامب يسايرها، وكان يتجه نحو وضع جماعة الإخوان المسلمين في العالم على قائمة الإرهاب؟ صحيحٌ أن تغييراً جذرياً لا يتوقع أن يحدث على الموقف الأميركي، لكن القبضة الحديدية التي أحاطت بالإسلاميين في الأعوام الماضية قد تتراجع، وقد يجدون مجالاً لالتقاط الأنفاس والتفكير في التعامل مع البيئة السياسية الدولية الجديدة.[[5]]
يعزز من هذه الفرضية، أولا أن بايدن ينظر إلى الإسلام باعتباره دينا كباقي الأديان، وقد عبر هو عن ذلك واستشهد ببعض آيات القرآن كوسيلة لاستقطاب أصوات المسلمين في الانتخابات، بينما ينظر ترامب إلى الإسلام باعتباره دينا متطرفا هو مصدر العنف والإرهاب في العالم. هذا التباين في النظرة إلى الإسلام ينبثق منه تباين في التصورت تجاه الإسلاميين وجماعة الإخوان المسلمين؛ فبينما يرى ترامب وفريقه واليمين المتطرف بشكل عام أن الحركات الإسلامية كلها راديكالية متطرفة تمثل شكلا من أشكال الإرهاب، ينظر بايدن وفريقه إلى الإخوان باعتبارها فصيلا إسلاميا معتدلا يمكن التعاون معه بما يضمن المصالح الأمريكية، خصوصا أن الجماعة حركة شعبية كبرى لها تأثير واسع على ملايين المسلمين؛ إضافة إلى أنهم يؤمنون بالتغيير السلمي عبر أدوات الديمقراطية، بعكس التنظيمات الأخرى محدودة التأثير والتي تعلن كفرها بالديمقراطية وأدواتها.
ثانيا، أن فريق إدارة بايدن، يضم كامالا هاريس، وسوزان رايس، وتوني بلينكن، وغيرهم من الأسماء التي عملت سابقاً في إدارة “أوباما”، وتتمتع بانفتاح على التعامل مع الجماعة. ووفق تقارير استخباراتية أمريكية، صادرة منذ سنوات، تدعمها مؤسسة “راند” البحثية التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، فإن الاتجاه المرشح ربما للظهور مجددا، يقوم على إحتواء وتوظيف جماعة الإخوان، والحوار معهم، مع التوصية بعدم تمكينهم.[[6]] وتذهب تقديرات إلى استبعاد ممارسة إدارة بايدن أي ضغط لعودة الإسلاميين إلى المشهد السياسي، وأن الضغوط الأمريكية قد تتركز فقط في ملف سجناء الرأي وحرية الرأي والتعبير. وبالتالي ستتوقف إدارة بايدن أيضا عن الدعم الصارخ الذي كانت تقدمه إدراة ترامب لنظام السيسي ونظم الطغيان العربي. وبالتالي فإن التغيير المرتقب مع الإدارة الأمريكية الجديدة هو تغيير شكلي لن يمس جوهر الاستبداد ولا شبكات المافيا السلطوية التي تهيمن على العالم العربي.
ثالثا، تعززت هذه الفرضية بإقرار الكونجرس في 22 ديسمبر 2020م قانون ميزانية الإنفاق الحكومي للعام المقبل، والذي تضمن المساعدات العسكرية المعتادة إلى مصر والتي تبلغ نحو 1.3 مليار دولار. ونص بند في القانون على تجميد 75 مليون دولار من المساعدات الأمريكية العسكرية لمصر إلى حين أن يرفع وزير الخارجية الأمريكي تقريراً لإطلاع المشرعين على التقدم المحقق من قبل القاهرة في مجال الإفراج عن السجناء. كما ربط بند آخر الإفراج عن 225 مليون دولار من المنحة بتعزيز مبدأ سيادة القانون ودعم المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان، بما يشمل حماية الأقليات الدينية. وقد اعتبر موقع مبادرة الحرية أن المشرعين الأمريكيين وجهوا رسالة قوية إلى مصر مفادها أن استخدامها المنهجي للاحتجاز لإسكات النشطاء والصحفيين لا يخدم مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة.
مصالح أمريكا مع الإسلاميين
تمثل التنظيمات المتطرفة كداعش والقاعدة حاجة ضرورية ومهمة لنظم الاستبداد العربي؛ فوجود مثل هذه التنظيمات يكفل للنظم تبرير جرائمها بدعوى ما تسمى بالحرب على الإرهاب، كما يسوغ لها الانتهاكات الواسعة ودحر الديمقراطية خوفا من هذا البعبع الذي يريد أن يقهر الناس بالسيف والعنف. أما التيارات الإسلامية الوسطية المعتدلة حقا فتمثل أزمة لنظم الاستبداد العربي؛ ذلك أنها تحظى بشعبية جارفة، وتمثل المنافس الأبرز لهذه النظم إذا جرت انتخابات حقيقية وفق أدوات الديمقراطية الصحيحة.
وتحتاج الولايات المتحدة والغرب عموما إلى الحركات الإسلامية المعتدلة كالإخوان المسلمين والحركات التي تؤمن بأفكار الجماعة؛ لأن وجودهم يمثل درعا يمنع التيارات الراديكالية المتطرفة من التوسع والانتشار، وقهر الإخوان واستئصالهم كما ترغب نظم الاستبداد العربي إنما يصب بشكل مباشر في تعزيز خطابات تنظيمات داعش والقاعدة وغيرها؛ وبالتالي فإن إخلاء الساحة من الإخوان إنما يفتح الباب واسعا أمام تعاظم خطر هذه التنظيمات، وبدلا من أن يكون أتباعها بالآلاف سيجدون أرضا خصبة لنشر أفكارهم بين ملايين اليائسين والمحبطين كما جرى بعد الانقلاب العسكري في مصر منتصف 2013م وبفعل سياسات الاستئصال التي تمارسها نظم الطغيان العربي بحق الجماعة وعناصرها والذين يقدرون بالملايين، وبفعل سد منافذ التغيير السلمي؛ فلا يجد هؤلاء المحبطون اليائسون سوى الانضمام إلى التنظيمات الراديكالية لمواجهة عنف الأنظمة المستبدة بعنف مماثل؛ ولعل هذا يفسر أسباب الانتشار الواسع لتنظيم داعش وإعلانه دولته في 2014م في أعقاب الانقلاب العسكري في مصر بسنة واحدة فقط.
ثانيا، من جانب آخر فإن الولايات المتحدة الأمريكية والغرب عموما يحتاجون إلى الحركات الإسلامية المعتدلة كالإخوان وغيرهم لضمان تحقيق مصالحها في مصر والمنطقة على المستويين القريب والبعيد، وذلك أمر يحتاج إلى تفسير؛ فالجماعة منذ الانقلاب العسكري منتصف 2013م تتعرض لحرب إبادة؛ وتمارس النظم بحقها انتهاكات مروعة، ومعلوم أن الولايات المتحدة الأمريكية والحكومات الغربية عموما تقوم في كثير من الأحيان بابتزاز حكومات الاستبداد العربي والضغط عليها بالورقة الحقوقية من جهة، وعدم احترامها للديمقراطية من جهة ثانية. وبالتالي فإن بقاء الجماعة على هذا النحو إنما يمثل أداة لواشنطن والغرب يبتزون بها حكومات العرب المستبدة وفق قواعد “الصفقة التاريخية”؛ وبالتالي يحقق الغرب بعض مصالحه بهذه الطريقة اللا أخلاقية على المستوى القريب. حيث تساوم الحكومات الغربية نظم الاستبداد العربي بين الانصياع لمصالح الغرب بشكل أعمى أو فضح انتهاكاتهم المروعة وتسليط إعلامهم ومؤسساتهم الحقوقية عليهم وربما تهديدهم بمحاكمات دولية كما يحدث حاليا مع السيسي في مذابح رابعة وقتل الرئيس مرسي بالإهمال الطبي. ومع بن سلمان بشأن اليمن ومقتل الصحفي جمال خاشقجي. أما على المستوى البعيد، فإن الجماعة تحظى بقاعدة شعبية واسعة وتعتبر الرقم الأهم في البلاد العربية إذا ما تمكنت الشعوب من إنهاء حقبة الاستبداد الراهنة؛ وتؤكد البحوث والدراسات الرصينة أن الجماعة ستحظى بمكانة كبيرة في البلاد العربية إذا ما دخلت المنطقة في مرحلة من الديمقراطية الحقيقية؛ وبالتالي فإن مصالح الأمريكان والغرب على المدى البعيد توجب عليهم وضع هذا السيناريو في الحسبان.
ثالثا، من جانب ثالث، لا تنسى الولايات المتحدة والغرب عموما الدور الكبير الذي قامت به جماعة الإخوان المسلمين والحركات الإسلامية في القضاء على الإمبراطورية السوفيتية التي كانت تمثل المنافس الأبرز للأمريكان في منتصف القرن العشرين؛ وجرى ذلك عبر تدخل الولايات المتحدة الأمريكية بنفوذها الواسع في دعم حركات الجهاد الأفغاني ضد الاحتلال السوفيتي لأفغانستان المسلمة؛ وهي الحرب التي وظفتها واشنطن وجندت خلالها الحكومات العربية من أجل إلحاق هزيمة مذلة بالسوفييت، لكنها انتهت فعليا بتمزيق الإمبراطورية السوفيتية وانهيار حلف وارسو الذي كانت تقوده موسكو كمنافس لحلف الأطلنطي الذي تقوده واشنطن. واليوم برزت إمبراطورية الصين الشعبية التي تمضي بإصرار نحو صدارة العالم على المستوى الاقتصادي والسياسي وحتى العسكري، وسط مخاوف أمريكية وصلت إلى حد إعلان الرئيس ترامب حربا اقتصادية على الشركات الصينية التي تتوغل وفق مخططات مرسومة للهيمنة على الاقتصاد العالمي والإطاحة بالولايات المتحدة، سعيا لتشكيل نظام دولي متعدد الأقطاب، وفي مرحلة تالية قد تنفرد الصين لتحتل مكانة واشنطن على المستوى الدولي. ويقوم الإعلام الغربي بتسليط الأضواء على ما تقوم به الحكومة الصنية من انتهاكات مروعة بحق أقلية “الإيجور” المسلمة. وإجبارهم على ترك الإسلام. فهل يمكن أن يتكرر الموقف مع الصين؟ وهل يمكن أن تتلاقى مصالح الأمريكان والغرب عموما مع الحركات الإسلامية ضد عدو واحد يمثل خطرا على الجميع؟ وهل يمكن أن تدعم واشنطن حربا جهادية جديدة ضد الصين كما دعمت الحرب الأفغانية ضد السوفييت؟
الخلاصة، بينما ينظر “ترامب” إلى الجماعة باعتبارها جماعة متطرفة، ينبغي تصنيفها على لائحة التنظيمات الإرهابية، فإن “بايدن” يتبنى الرؤية نفسها للرئيس السابق “أوباما”، باعتبار الجماعة معتدلة، ويمكن التعاون معه، بصفتها أكبر وأقدم حركة إسلامية في العالم. وعلى الرغم من وجود مشروع قرار للإدارة الأمريكية، لتصنيف جماعة “الإخوان” على قائمة الإرهاب، منذ فبراير/شباط 2016، فإن المؤسسات الأمريكية المحترفة في وزارتي الخارجية والدفاع، حالت دون ذلك، بالنظر إلى قبول الجماعة بالعمل السياسي، والمشاركة في الانتخابات، ونبذها العنف والإرهاب.[[7]]
تدرك الأنظمة الاستبدادية والحركات الإسلامية في المنطقة أن جوهر المقاربة الأمريكية في الشرق الأوسط يتعلق بتحقيق الاستقرار، في حدود من الدكتاتورية الممكنة، وتمكين “إسرائيل” لتبقى قابلة للاستدامة والاستمرار. وإذا كان ترامب قد أطلق العنان للدكتاتوريات ولإسرائيل بالتصرف دون قيد أوحد، سوى حدود القوة والقدرة، فإن بايدن يضع مفهوم القوة في سياق الدبلوماسية، ويحاجج بأن نهج ترامب يقوض القوة الأمريكية الناعمة التي ترتكز إلى الدفاع عن الديمقراطية والليبرالية، ولذلك فإن الجدل في المنطقة يتمحور حول حدود الدكتاتورية والديمقراطية.
من الصعب أن تستجيب الإخوان لاشتراطات الديكتاتورية والقبول بإسرائيل، بما يمثل انقلابا على أفكارها ومبادئها لتتوافق مع متطلبات “الاعتدال” كما تريده واشنطن وتروج له الأنظمة العربية المستبدة؛ ولذلك فإن أقصى ما يمكن أن يذهب إليه بايدن هو تخفيف الضغوطات التي تمارسها الدكتاتوريات المحلية وحليفتها الاستعمارية الإسرائيلية على الجماعة، وخلق حالة من التوازنات خوفاً من حدوث انفجارات اجتماعية تعيد صياغة ثورات الربيع العربي، وهي المحددات التي تحكم السياسة الأمريكية في المنطقة بالتعامل مع الحركات الإسلامية من نظريات الإدماج إلى مقاربات الإقصاء.
الحديث عن تغيّر أمريكي جذري تجاه التعامل مع الإسلام السياسي في عهد بايدن لا يعدو عن كونه وهماً، فقد برهنت سياسة الرئيس الأمريكي الديمقراطي الأسبق أوباما، التي يعد يايدن امتداداً لها، عن التزام الولايات المتحدة بدعم الأنظمة الاستبدادية، وغياب رؤية ومقارية محددة حول الإسلام السياسي. التغير المنشود في تعاطي إدارة بايدن مع الحكومات العربية المستبدة سيكون شكليا ولن يتجاوز الضغوط الإعلامية والرسمية بشأن الملف الحقوقي وملف حرية الرأي والتعبير. ورغم ذلك، قد تصلح إدارة “بايدن-هاريس” بعض ما أفسدته إدارة “ترامب” في علاقاتها مع جماعة الإخوان، أو على الأقل وقف حرب استئصالها، والتوقف عن الدعم العلني والقوي لنظام “السيسي”، وعدم منحه شيكا على بياض لما يرتكب من انتهاكات وجرائم ضد المعارضة المصرية بكافة أطيافها السياسية.
[1] “الإخوان”: ندعو إدارة بايدن لمراجعة “سياسات دعم الدكتاتوريات”/ الأناضول 8 نوفمبر 2020
[2] نائب مرشد الإخوان يتوقع حدوث تغيير بالمنطقة مع قدوم بايدن/ الخليج الجديد الأحد 6 ديسمبر 2020
[3] محمد أبو رمان/ هل سيتنفس الإسلاميون الصعداء؟/ العربي الجديد 12 ديسمبر 2020
[4] حسن أبو هنية/ ما هي مقاربة بايدن تجاه الإسلام السياسي؟/ “عربي 21” الأحد، 13 ديسمبر 2020
[5] محمد أبو رمان/ هل سيتنفس الإسلاميون الصعداء؟/ العربي الجديد 12 ديسمبر 2020
[6] الإخوان وبايدن.. انفراجة منتظرة مشوبة بالحذر من سيناريو أوباما/ الخليج الجديد الأربعاء 18 نوفمبر 2020
[7] الإخوان وبايدن.. انفراجة منتظرة مشوبة بالحذر من سيناريو أوباما/ الخليج الجديد الأربعاء 18 نوفمبر 2020