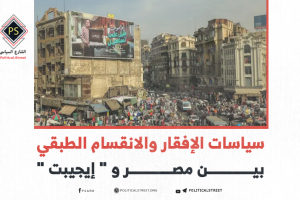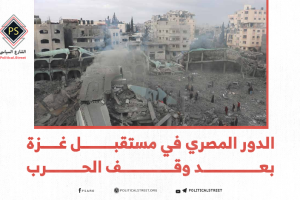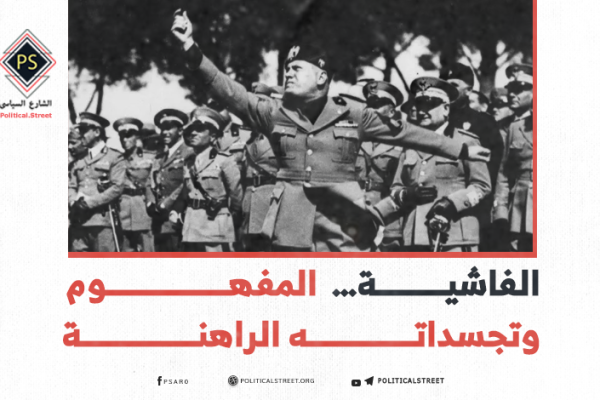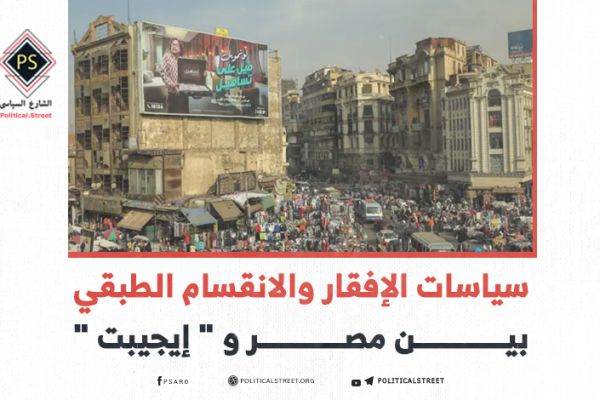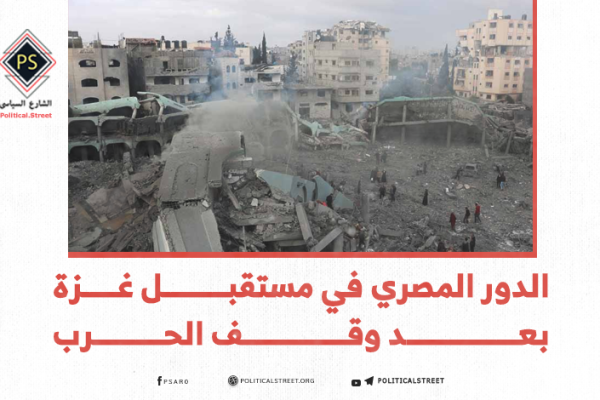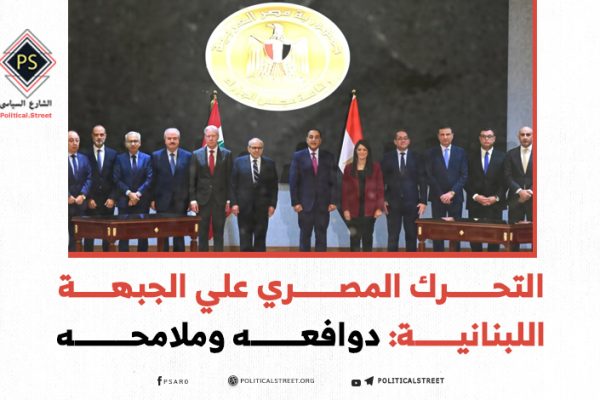موقف مصر من الخلاف بين السعودية والإمارات
أقدم المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، في 3 ديسمبر 2025، على تنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق، تمكن خلالها من بسط سيطرته على محافظتي حضرموت والمهرة، في خطوة مثلت تهديدًا جوهريًا للسعودية؛ حيث تشكل حضرموت والمهرة العمق الحدودي المباشر مع المملكة العربية السعودية، وبوابة اليمن على بحر العرب. ما دفع السعودية، إلي تنفيذ أولى الضربات الجوية التي استهدفت مواقع تابعة لقوات المجلس في حضرموت، في 26 ديسمبر 2025. ثم جاءت الضربة النوعية في 30 ديسمبر 2025 ضد سفن ومعدات عسكرية في ميناء المكلا، ثبت ارتباطها بخطوط إمداد قادمة من ميناء الفجيرة دون تصاريح رسمية، لتشكل لحظة فارقة في مسار التحول السعودي. فاستهداف شبكات الإمداد لا المواقع القتالية فقط، عكس استعداد الرياض لكشف وتعطيل أي أدوار مزدوجة لدولة الامارات داخل التحالف، وإنهاء مرحلة إدارة التباينات خلف الكواليس. في اليوم نفسه، أعلنت الإمارات سحب ما تبقى من قواتها من اليمن. ورغم تقديم القرار إعلاميًّا بوصفه إعادة تموضع، فإن توقيته المتزامن مع الضربة الجوية في المكلا كشف طبيعته الحقيقية كـانسحاب وقائي من ملف أصبح عالي التكلفة، واختيارًا لتفادي الاصطدام المباشر مع التوجهات الصارمة السعودية الجديدة التي أعادت رسم حدود الدور المسموح به لكل طرف داخل التحالف. أدى هذا الانسحاب إلى تجريد المجلس الانتقالي الجنوبي من غطائه الإقليمي الأساسي، وتركه مكشوفًا أمام الضغط العسكري والسياسي السعودي، مما سرع من عزلته الداخلية، ومهد لانهياره القيادي والسياسي خلال الأيام اللاحقة. وتجلى هذا الأمر بوضوح مع هروب رئيس المجلس، عيدروس الزبيدي، خارج البلاد. ثم في 9 يناير 2026، جاء إعلان حل المجلس الانتقالي الجنوبي تتويجًا لهذا الانهيار1. أولًا: التعامل المصري مع الخلاف السعودي الإماراتي: اتخذ التعامل المصري مع الخلاف السعودي الإماراتي عدة أشكال، تمثلت في: 1- أصدرت الخارجية المصرية بيانًا رسميًا، في 30 ديسمبر 2025، تعليقًا على تطورات الأزمة السعودية – الإماراتية في اليمن، أكدت فيه القاهرة علي متابعتها باهتمام بالغ التطورات الأخيرة على الساحة اليمنية، مؤكدة إجراء اتصالات مكثفة مع الأطراف المعنية بهدف خفض التصعيد. كما أعرب البيان عن ثقة مصر في حرص كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة على التعامل بحكمة مع المستجدات، وعلى تغليب قيم التعاون والأخوة بين البلدين2. اتسمت صياغة البيان بالتحفظ واعتماد مقاربة وسطية، من دون تأكيد صريح على وحدة الأراضي اليمنية، فُسر هذا التوجه باعتباره منسجمًا مع الموقف الإماراتي الداعم لإعادة تشكيل الوضع في جنوب اليمن عبر كيانات محلية موالية لها3. وفي 5 يناير 2026، زار وزير الخارجية السعودي القاهرة للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي. وعقب اللقاء، أفادت رئاسة الجمهورية المصرية بأن المباحثات أكدت تطابق الموقفين المصري والسعودي بشأن ضرورة التوصل إلى حلول سلمية لأزمات المنطقة، بما يضمن وحدة الدول وسيادتها وسلامة أراضيها، ولا سيما في السودان واليمن والصومال وقطاع غزة4. وتذهب تحليلات إلى أن الجانب السعودي كان يسعى إلى موقف مصري أكثر وضوحًا إزاء مسألة وحدة اليمن، بما ينسجم مع الرؤية السعودية، في مقابل الطرح الإماراتي الداعم لإعادة تشكيل الوضع في جنوب اليمن عبر قوى محلية موالية للإمارات. غير أن البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية المصرية عقب اللقاء ركز على التأكيد المشترك على وحدة وسيادة عدة دول عربية، من بينها اليمن والسودان والصومال، دون تخصيص اليمن وحده، وهو ما فُسر على أنه محاولة للحفاظ على توازن دقيق في العلاقات مع الطرفين. في المقابل، قدم محللون سعوديون قراءة مغايرة، معتبرين أن البيان المشترك الصادر في القاهرة بعد الزيارة يعكس تقاربًا مصريًّا–سعوديًّا في ملفات إقليمية رئيسة، لا سيما اليمن والسودان والصومال. وذهب بعضهم إلى توصيف هذا التقارب باعتباره مؤشرًا على إعادة تموضع سياسي لمصر باتجاه تعزيز ما يُسمى بـ”الارتكاز العربي”، في مواجهة مشاريع تفكيك الدولة الوطنية في الإقليم التي تقودها الإمارات5. 2- نقل موقع “ميدل إيست آي” عن مصدر بالرئاسة المصرية، في 13 يناير الجاري، تأكيده مشاركة مصر معلومات استخباراتية وتسجيلات مع السعودية عن نشاط الإمارات وأهدافها في اليمن، وعن دعمها “مليشيا الدعم السريع” بالسودان، فيما أشار الموقع إلى طلب الرياض من القاهرة تجهيز قواتها البحرية لقطع خطوط الإمداد المحتملة من أبوظبي إلى جنوب اليمن. وذلك وسط تصاعد التوترات بين السعودية والإمارات، وفي توقيت ينظر فيه المصريون إلى دعم الإمارات للجماعات المسلحة والانفصالية في اليمن والسودان وصوماليلاند باعتباره تهديدًا للأمن القومي المصري. في المقابل، ووفق الموقع البريطاني، “أثار تبادل المعلومات الاستخباراتية غضب أبوظبي”، ناقلة عن مصدر مصري آخر، تأكيده اعتراض الإمارات وتوجيهها تحذيرًا من تحسين علاقات القاهرة مع الرياض على حسابها، وتلويحها باستثماراتها في مصر6. 3- في إطار حصار السعودية النفوذ الإماراتي في إقليم الشرق الأوسط، أكدت وكالة “بلومبيرغ”، في 8 يناير الجاري، سعي تركيا للانضمام لتحالف دفاعي سعودي باكستاني، ما قرأ فيه خبراء بأنه تمهيد لتغير ميزان القوى في الشرق الأوسط، دون حضور مصري. إلا أن وكالة “بلومبيرغ”، قالت إن السعودية بصدد تشكيل تحالف عسكري جديد مع الصومال ومصر، في إطار الحد من النفوذ الإقليمي للإمارات، وذلك بعد أن ألغت الصومال اتفاقيات أمنية وموانئ مع الإمارات، وذلك في ظل حضور عسكري مصري متسارع في الصومال في إطار اتفاقية عسكرية أُبرمت العام الماضي (2025). وفي مقابل قرار الصومال تعليق جميع الرحلات العسكرية الإماراتية في أجوائه وسماحها لأبوظبي سحب ما تبقى من أفرادها ومعداتها العسكرية دون إخضاعها لأي تفتيش، ومع أنباء بحث الإمارات عن مسارات طيران بديلة إلى ليبيا بعيدًا عن أجواء الصومال والسعودية ومصر؛ تزايد الحضور العسكري المصري بمقديشيو7. 4- شهد دور مصر في حصار النفوذ الإماراتي بالإقليم تطورًا غير مسبوقًا، منذ تفجر أزمة الحرب السودانية في أبريل 2023، بين “مليشيا الدعم السريع” بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) المدعومة إماراتيًا، والجيش السودان المدعوم من مصر وتركيا والسعودية، كمؤسسة شرعية. إذ تشير الأنباء إلى ضرب الجيش المصري ولأول مرة إمدادات عسكرية قرب العوينات كانت قادمة من الإمارات عبر قوات خليفة حفتر بليبيا، إلى مليشيا الدعم السريع، وسط أنباء عن إبلاغ القاهرة حفتر بضرورة الخروج من مشروع “الإمارات- حميدتي”8. وفي هذا السياق، عقدت مصر لقاءات دبلوماسية وتحركات فاعلة على الأرض في إطار تحالف مصري سعودي تركي أسفر مؤخرًا عن إبرام صفقة أسلحة للجيش السوداني من باكستان، بقيمة تُقدر بنحو 1.5 مليار دولار، في صفقة وُصفت بأنها الأضخم منذ اندلاع الحرب في البلاد، في ظل توجه يسعى لتضييق الخناق على الدور الإماراتي، وإزاحة الدعم السريع ودمجه داخل قوات الجيش والشرطة، وصولًا لإيجاد حل سياسي ينهي الحرب. ويبدو أن القاهرة تسعي إلي تشكيل تحالفات مماثلة في القرن الأفريقي لمواجهة التحالف بين إسرائيل والإمارات وإثيوبيا9. 5- كشف موقع “ميدل أيست آي” نقلًا عن مصدر رفيع في الرئاسة المصرية قوله إن الخلاف المصري الإماراتي اتضح هذا الشهر (يناير 2026) عندما رفضت الشركة القابضة للنقل البحري والبري المملوكة للدولة في مصر عرضاً من شركة بلاك كاسبيان…