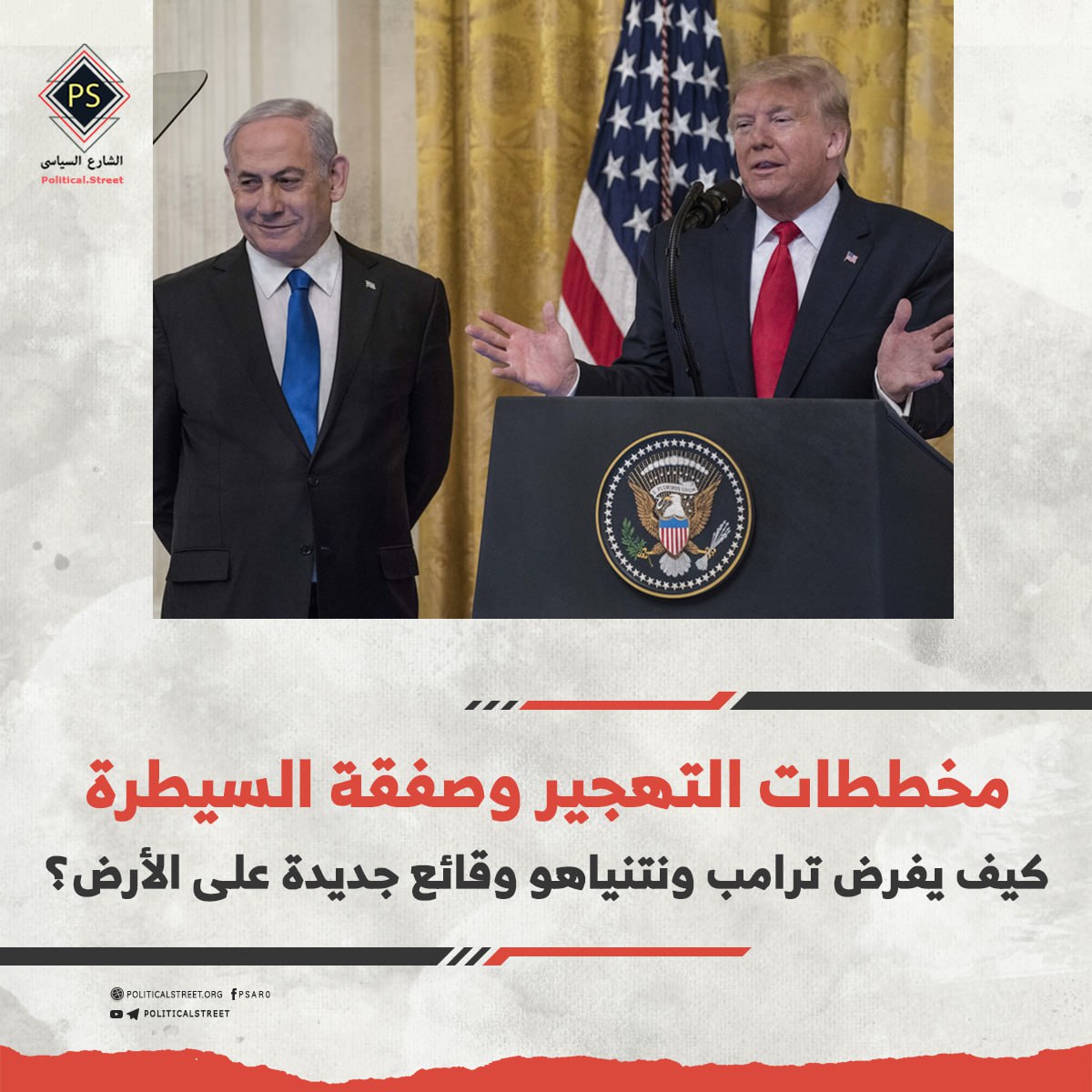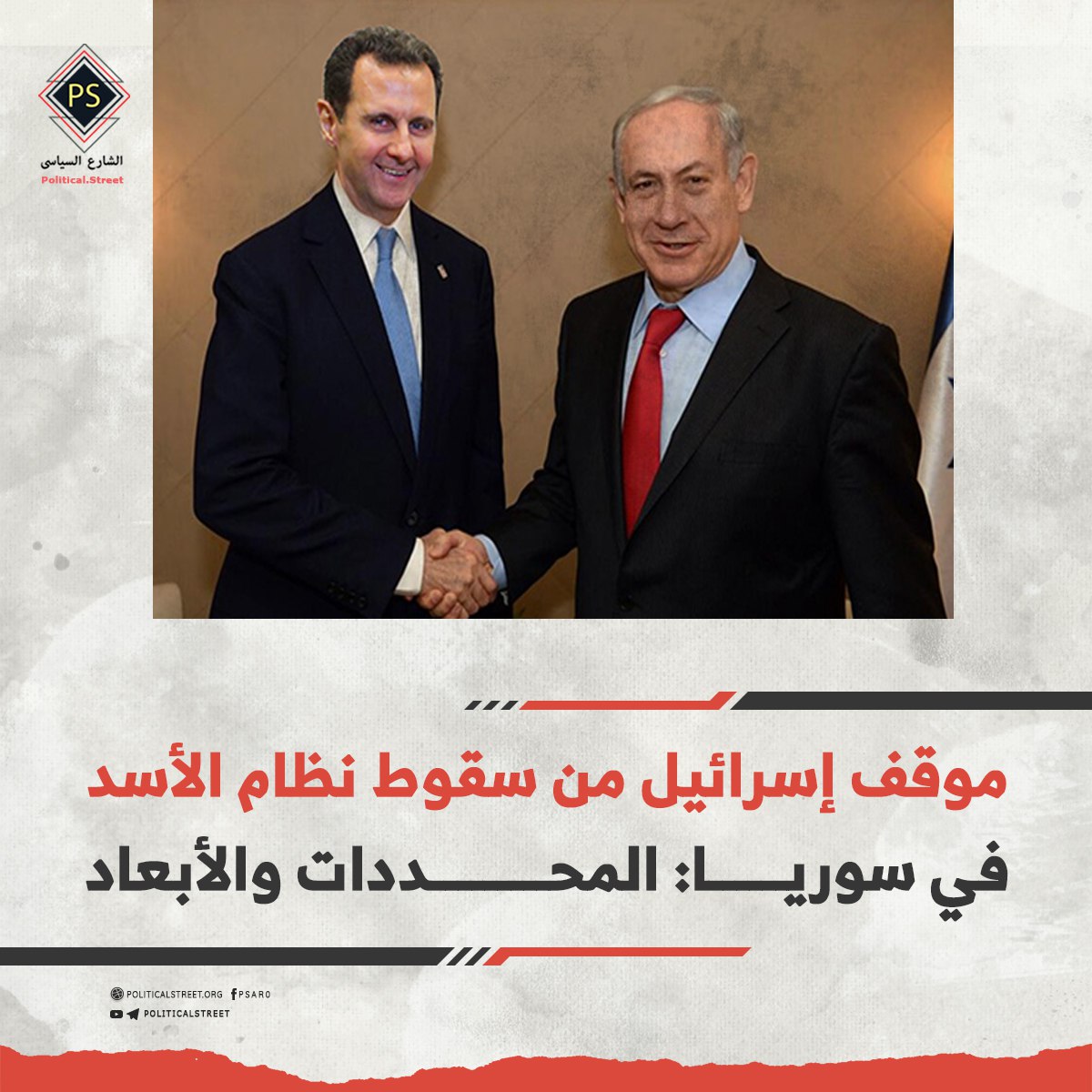أزمة الأطباء في مصر أبعد من قانون المسئولية الطبية
كشف الصراع بين الحكومة وقطاع الأطباء في مصر، خسلال صياغة قانون المسئولية الطبية، المثير للجدل ، الكثير من الاشتباكات والأزمات التي تواجه مهنة الطب في مصر.. وعلى الرغم من محاولات تبريد المواجهة من قبل الحكومة، باحراء تشريعي غير كاف، بحذف مادة الحبس الاحتياطي، من القانون، إلا أن الأطباء ما زالوا يعايشون أززمات عدة، باستمرار وجود لجان محاسبة لهم، يس من أعضائها أطباء، بل من النيابة العامة، بجانب غرامات كبيرة تقودهم أيضا للحبس،علاوة على ذلك تتفابم أزمات تدني الرواتب وانخفاض البدلات وضعف الامكانات الطبية بالمستشفيات، وبجانب عدم الحماية الكافية لهم من الاعتداءات.. ورغم أن القانون الذي لا يرضي الأطباء، يواجه رفضا كبيرا بمجتمع الأطباء، إلا أن الحكومة ترى أن هذا القانون يحقق الاتزان ، ورأت فيه انها وانه هو الطريقة الامثل بالتعامل مع قضايا الاهمال الطبي والاخطاء الطبيه نص القانون أيضًا على إنشاء اللجنة العلaيا للمسؤولية الطبية وحماية المريض، التي تتبع رئيس الوزراء وتعدّ جهة استشارية معنية بالنظر في الأخطاء الطبية، وتتولى اللجنة مهام (النظر في الشكاوى، إنشاء قاعدة بيانات، وإصدار أدلة إرشادية للتوعية بحقوق المرضى بالتعاون مع النقابات والجهات ذات الصلة). فضلًا عن ذلك، يتضمن مشروع القانون إنشاء نظام للتأمين الإلزامي يشمل المنشآت الطبية ومقدمي الخدمات من العاملين في المهن الطبية، من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي، ويتولى الصندوق المساهمة في دفع التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، إلى جانب إمكانية تغطية الأضرار الأخرى التي قد تحدث أثناء أو بسبب تقديم الخدمات الطبية، حتى وإن لم تكن مرتبطة بأخطاء طبية. وترى الحكومة إن القانون “متزن”، وأثناء مشاركته بالجلسة العامة التي عقدها مجلس الشيوخ لمناقشة القانون، أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة، خالد عبد الغفار، أن “فلسفة القانون تستهدف تحقيق التوازن والتكامل بين الطبيب والمريض، مشيرًا إلى أن التشريع يمنح الحماية الجنائية للأطباء، ويوفر بيئة عمل آمنة للطواقم الطبية، بعد أن تكررت حوادث التعدي على الأطباء”. كذلك صرح وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي محمود فوزي، بأن القانون الجديد يهدف إلى تعزيز الثقة المتبادلة بين الطبيب والمريض، وتحقيق جودة أعلى في تقديم الخدمات العلاجية، وأوضح أن التشريع يتضمن ضمانات للأطباء، من أبرزها تعريف دقيق للخطأ الطبي، وتحديد الحالات التي تُعفى فيها مسؤولية الطبيب ومقدمي الخدمة الطبية. اعتراضات الأطباء بالمقابل تعترض نقابة الأطباء بشكل واسع على القانون، إذ دعت إلى عقد جمعية عمومية طارئة، ، لمناقشة كيفية مواجهته، وقال نقيب الأطباء، أسامة عبد الحي، في تصريحات صحفية إن” القانون الجديد لا يحقق مصلحة الطبيب والمريض. ورغم أهمية التشريع لتنظيم العلاقة بين مُقدم ومتلقي الخدمة الطبية، فالصيغة الحالية لا تحقق الغاية من صدور القانون”. كما أكد نقيب الصحفيين خالد البلشي، تضامنه مع مطالب نقابة الأطباء، داعيًا إلى إجراء تعديلات جوهرية على القانون قبل عرضه على مجلس النواب، بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وحماية الأطباء. بعد الضغوطات، أعلنت لجنة الصحة بمجلس النواب، حذف مادة الحبس الاحتياطي من القانون، وقالت إن القرار جاء استجابة لمطالب الأطباء، فيما أكدت نقابة الأطباء تمسكها بمطالبها وجددت دعوتها للجمعية العمومية الجمعة، وقال الدكتور جمال عميرة – وكيل نقابة الأطباء-، في تصريحات تلفزيونية، إن إلغاء مادة الحبس الاحتياطي بمشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض هو استجابة لواحدة من خمس مواد طلبت النقابة تغييرها، وأضاف أن ” اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب ا لم يناقش أمورًا جوهرية”، مشيرًا إلى أن “مشروع القانون لا يزال ينص على حبس الأطباء في الأخطاء المهنية، وهو أمر غير موجود بأي مكان في العالم”، وفق قوله. واستنكرت منى مينا – الأمين العام السابق لنقابة الأطباء- إقرار لجنة الصحة بمجلس النواب تعديلات قانونية، والقول بإنها جاءت استجابة لمطالب نقابة الأطباء، مشيرة إلى أن “البعض يهلل لهذه التعديلات رغم ما تحمله من أعباء جسيمة على الأطباء.” إذ أن المادة 27 المعدلة تنص على غرامة تتراوح بين 100 ألف جنيه ومليون جنيه عن الأخطاء الطبية التي تُسبب ضررًا محققًا، بينما تصل العقوبة إلى السجن لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات وغرامة بين 500 ألف ومليون جنيه إذا كان الخطأ جسيمًا، لافتة إلى أن الغرامة تُعتبر عقوبة جنائية يتحملها الطبيب شخصيًا، ولا تغطيها شركات التأمين التي تقتصر مسؤوليتها على التعويض المدني كما منح مشروع القانون (المادة 29) النيابة العامة حق حبس الأطباء احتياطيًا في الجرائم التي تقع نتيجة تقديم الخدمة.. كما أن التعريفات القانونية المتعلقة بالأخطاء الطبية ما تزال فضفاضة وتسمح بتفسيرات متعددة، ما يُزيد من مخاطر تحميل الأطباء مسؤولية جنائية في ظل غياب وضوح كافٍ. مشيرة إلى أن المادة 23 من القانون لم تُلغَ، إذ تتيح فرض عقوبات أشد إن وُجدت، رغم أن العقوبات الحالية تُعد من الأشد بالفعل. وشددت على ضرورة مراجعة هذه التعديلات لتفادي التضييق على الأطباء في ظل التحديات التي تواجههم يشار إلى أنه خلال المناقشات التي شارك فيها نقيب الأطباء، أسامة عبد الحي، ونقيب الأسنان، إيهاب هيكل، بمجلس الشيوخ أكدت النقابة أنها تتمسك بمجموعة من المطالب الأساسية العادلة، منها رفض حبس الأطباء في القضايا المهنية، وقصر المسؤولية الجنائية على الأفعال المخالفة لقوانين الدولة أو الممارسات خارج التخصص الطبي، مع استبدال الحبس بالتعويضات في حالة الأخطاء غير العمدية، مشددة على عدم جواز الحبس الاحتياطي في القضايا المهنية، وضرورة أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الجهة المختصة بتقييم الأخطاء الطبية والفصل فيها. وأضافت النقابة، بحسب بيان، أن مشروع القانون بصيغته الحالية لم يستجب لـ مطالبها المتعلقة بإنشاء صندوق تعويضات يتحمل كامل قيمة التعويضات دون مشاركة الطبيب في التمويل، مشيرة إلى أهمية أن يكون دور اللجنة العليا للمسؤولية الطبية محوريًا في التحقيق والتقاضي، بما يضمن الحياد والعدالة، مع توفير الحماية القانونية للأطباء أثناء ممارسة مهنتهم، بما يحقق التوازن بين حقوق المرضى ومقدمي الخدمات الصحية. وبحسب وكيلة نقابة الأطباء السابقة، منى مينا، فإن النقابة منذ أكثر من عشر سنوات، كانت أول جهة تطالب بإصدار قانون المسؤولية الطبية، بهدف وضع طريقة محاسبة علمية ومهنية لأي اتهام بالإهمال الطبي أو الخطأ الطبي، وتقدمت بقانون في وقت سابق، وتم إهماله، وبعدها تم إقرار القانون الراهن (المثير للجدل). تضيف: “نحن لا ننكر وجود أخطاء طبية، أو بعض حالات إهمال ربما يصل عدد منها إلى الإهمال الجسيم، هذه الأمور موجودة كأي مهنة أخرى، لكن المشكلة تكمن في ضرورة وجود قانون يفرق بين المضاعفات الطبيعية لأي تدخل طبي، والأخطاء الطبية، والإهمال الجسيم.” فيما يتفق معها أحمد حسين – عضو مجلس النقابة السابق-، إذ يؤكد أن أطباء مصر لا يرفضون القانون بالمطلق، ومنذ سنوات يطالبون بوضع قانون عادل وموضوعي للمسؤولية الطبية. يضيف: “مثل هذه القوانين موجودة في غالبية الدول التي تطبق أنظمة صحية مستقرة ومحترمة وتراعي مصالح المرضى. هذه الدول نجحت في تحقيق حالة من الرضا لدى المرضى تجاه أنظمتها الصحية. دائمًا…