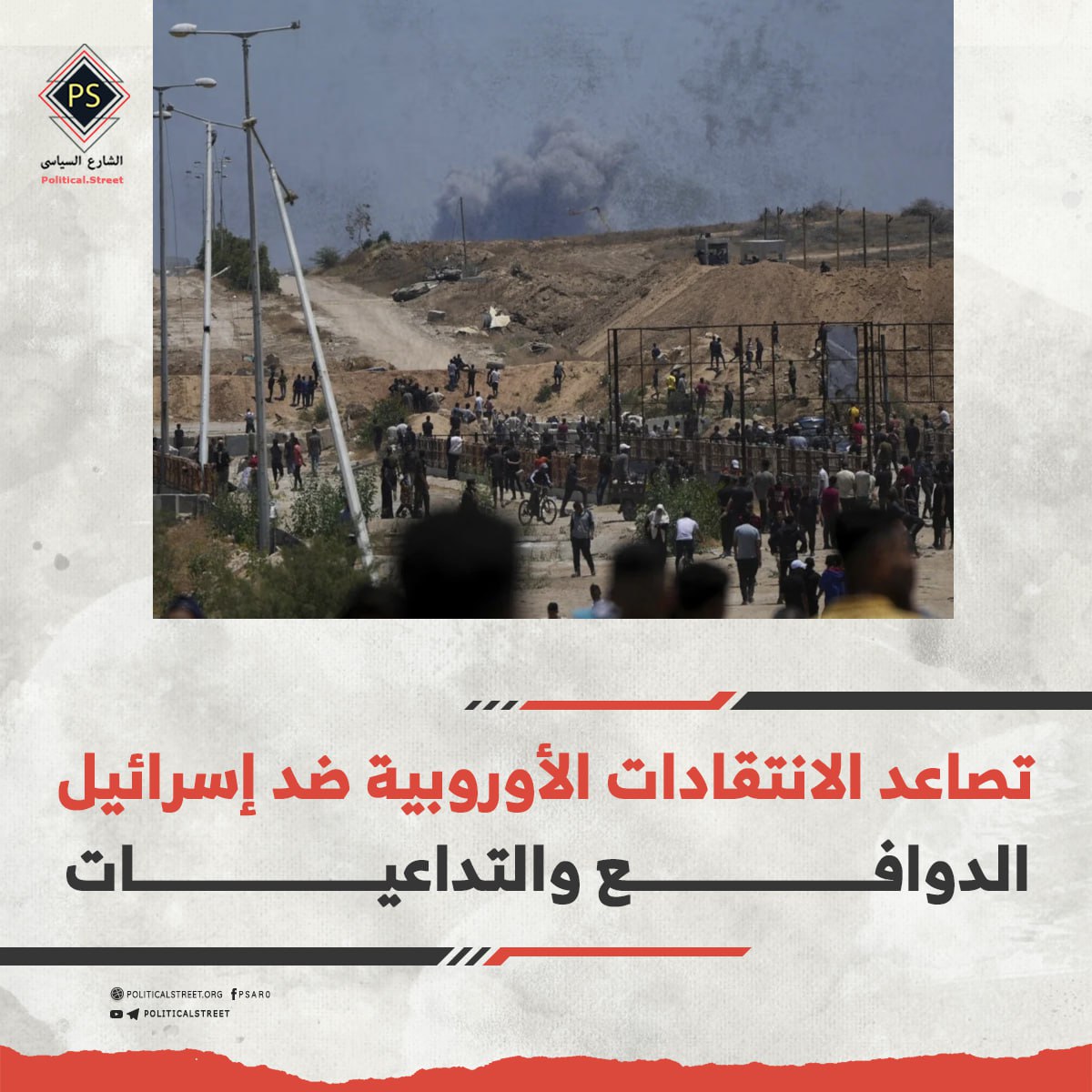الموقف التاريخي المصري تجاه غزة ومعبر رفح
منذ سنوات طويلة يُشكّل القطاع المحاصر لأهل غزة وحاجتهم إلى معبر رفح مصدر حساسية لدى النظام المصري. ففي أعقاب سيطرة حركة حماس على غزة عام 2007 حَجَرَتْ القاهرة المعبر تمامًا بالتنسيق مع إسرائيل بذريعة منع تسلل مسلحي الحركة وانتشار الإرهاب في سيناء وعلى مدى العقدين الماضيين تعاقبت مراحل: فتح رمزي بسياسات مرسي (2012–2013) ثم إغلاق كامل شديد تحت حكم السيسي بعد 2013. لقد صدّرت مصر مع حبيبها الإسرائيلي رواية «المخاوف الأمنية» حتى جعلت قطاع غزة «سجنًا مفتوحًا» لا يسمح إلا بدخول القليل من المساعدات عبر معابر إسرائيلية وفي الوقت نفسه تكرر القاهرة شعارات «الدعم الثابت للفلسطينيين» في بيانات رسمية، لكنها عمليا تتبع سياسة تضييق على غزة. فقد كشفت مصادر حقوقية أن نظام السيسي «أصبح شريكًا رئيسًا في إغلاق المعبر منذ 2007» وسعى لجني أرباح من الأزمة عبر رفع رسوماً باهظة لتصاريح الخروج والدخول. و بحسب تحقيقات إعلامية، كان المعبر “يفتح فقط للموتى” تقريبًا – إذ عمد ضباط أمن مصريون إلى إعادة 25 ألف حالة إنسانية طلبت العبور من غزة قبل بداية الحرب الحالية، من دون موعد معلوم. إجراءات السلطات المصرية تجاه «الصمود» و«مسيرة الحرية» خلال الفترة المذكورة (9–14 يونيو 2025) تبنّت أجهزة الأمن والسلطات المصرية سياسة صارمة تجاه قافلتي التضامن. فمن الجانب الإداري أُعلن رسميا وجوب الحصول على موافقات مسبقة صارمة لدخول المنطقة الحدودية (العريش ورفح)، وإتمام أي زيارة ضمن “الإجراءات المتّبعة منذ بدء الحرب”. وأوضحت الخارجية المصرية أن أي طلب خارج هذه الضوابط «لن يُؤخذ بعين الاعتبار». عمليًا، صعّدت الأجهزة الأمنية الأساليب القمعية: استُهدف النشطاء فور وصولهم للقاهرة؛ فقد انتشرت قوّات الأمن (وبرعاة بزي مدني يُرجّح أنهم من البلطجية) في فنادق المطار ومدن القناة لاعتقالهم ومصادرة أمتعتهم وجوازاتهم وجرى احتجاز وترحيل عشرات النشطاء من دون أسباب قانونية واضحة. مثلاً وثّق ناشطون تعرض سيدات عربيات لأعمال عنف واعتقال تعسفي رغم حصولهن على تأشيرات شرعية على مداخل سيناء نشرت الشرطة «حواجز» لمنع وصول القافلة إلى رفح، وأطلق مواطنون مسلحون وبلطجية مأجورون يدعمهم النظام هجومًا على المشاركين قرب الإسماعيلية وبذلك أغلقت مصر الباب أمام أي محاولة فك عزلة غزة برا. هذه الإجراءات الإدارية والأمنية أثّرت عمليًا على سير القافلتين: فقد مُنع كثير من المشاركين من مواصلة التوجه باتجاه معبر رفح أو حتى دخول سيناء، بالرغم من إعلان المنظمين احترامهم للإجراءات الرسمية وعدم نيّتهم اختراق الحدود دون موافقة البعد الإقليمي والدولي للموقف المصري لم يكن الموقف المصري منعزلاً عن توازنات إقليمية؛ فقد برزت شراكة واضحة مع الضغوط الإسرائيلية والأميركية. مثلاً حثّ وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس علناً مصر على منع أي «مسيرة» أو قافلة لكسر الحصار، ووصَم المشاركين بأنهم «جهاديون» يهددون «النظام المصري وسائر الأنظمة العربية المعتدلة». هذه الدعوات علنية، وتكشف عن انسجام الموقف المصري مع التحذيرات الإسرائيلية. كما أشارت تقارير إلى ضغوط غربية (نُقلت عنه أن فرنسا والولايات المتحدة تواصلا مع مصر بشأن مواطنيها المعتقلين)، واعتراف دبلوماسي فرنسي بأن «تأمين الحماية القنصلية» لمواطنيه حظي بتفاهم مع القاهرة. وفي المقابل تؤكد القاهرة تمسكها بورواية أنها ضحية فرض الحصار. ففي بياناتها الرسمية شدّدت مصر على «تثمين دعم الصمود الفلسطيني» ومعارضة «التجويع الإسرائيلي»، كما كرّرت أن جانبها من معبر رفح «مفتوح وجاهز» وأن المنع هو نتيجة سيطرة إسرائيل على الجانب الآخر. باختصار، الموقف المصري رسميًا يحرّض على الضغط على إسرائيل وليس على فتح الحدود، لكنه عمليًا ينفذ ما تشي به إرشادات البلدين الحليفين (أمريكا وإسرائيل) للحفاظ على «الأمن القومي المصري» على حد زعمهم. خطاب الإعلام الرسمي المصري والتناقض بينه وبين الواقع رسميا، تكرّر السلطات الكبرى المواقف التقليدية: تستقبل صحيفة «الأهرام» بيانات الخارجية بعبارات تضامن، وتردد الفضائيات المقربة من السلطة عبارات «الثبات مع غزة». على سبيل المثال، خرج الناطق الرسمي ليعلن: «نرحب بالمواقف الداعمة لغزة» و«نؤكد ضرورة الضغط على إسرائيل لرفع الحصار». ومع ذلك فإن الإعلام الموالي كشف التناقض الفج. فرجال النظام مثل الإعلامي أحمد موسى وصحف موالية وصفت القافلة بأنها «فخ إعلامي يحرج مصر»، بل شككت في نوايا المشاركين وسعت لدفع الرأي العام المصري ضدهم. المفارقة هنا أن المتحدثين الرسميين يذرفون دموع التنديد بإسرائيل، بينما شقيقاتهم السرية من الأمن تفعّل أعمال العنف ضد متضامنين سلميين. فبينما طالبت القاهرة علنًا «وقف الحرب» و«تيسير دخول المساعدات»، بيّنت الوقائع أنها منعت أي قافلة محمّلة بأي مساعدة حرة. هذا الشعار الرنان (دعم صمود الفلسطينيين) يتناقض مع الممارسة (إجراءات قمعية وعرقلة الدعم). وحتى خطوة النشطاء وندائهم المستمر – ذكرًا وإسلامًا (وفق تصريحاتهم) – بمنحهم تصاريح قبل المجازفة بكسر الحصار لم تُلقَ آذانا صاغية مقارنة بالمواقف العربية والدولية الأخرى لم يستجِب أي نظام عربي بشكل حقيقي لهذه المبادرات التضامنية. ففي الجوار المغاربي أُطلقت «قوافل الصمود» من تونس والجزائر وليبيا والمغرب، ولاقت شعبيّة وحماسًا واسعَيْن عند إطلاقه إلا أن المواقف الرسمية كانت متفاوتة: فقد رحّب الغرب الليبي بالقافلة ووفّر لها الدعم اللوجستي في طرابلس ومصراتة، بينما قضّى شرق ليبيا على مشروعها فجأة وأسْقَطها قسريًا عند بوابة سرت بزعم «عدم وجود إذن» تونس والجزائر أعلنتا دعمًا ضمنيًا عبر السماح بانطلاق القوافل من أراضيهما، والمغرب سمح بمشاركة مواطنين مغاربة فيها. أما الدول العربية الكبرى (السعودية، والإمارات، والأردن، وغيرها) فإن كل ما صدر عنها هو بيانات عامة تندّد بما يجري في غزة، دون أن تبادر إلى فتح معبر أو تنظيم دعم فعلي؛ فالخطابات الرسمية اكتفت بمطالبة المجتمع الدولي بوقف الحرب. والأكثر من ذلك، اتخذت الدول المطبعة مع إسرائيل موقف الحياد الفعلي: فمثلًا اعتبر وزير إسرائيلي المشاركين «أعداء للأنظمة العربية» ولا وجود لدولة عربية تجرؤ على المخاطرة بقرار كهذا ضد إسرائيل أو ضغوطها على مصر. باختصار، تميّز المنطق العربي السائد بعدم المساس بما تُقرّه القاهرة، حتى إذا كان يعني التضحية بالإنسانيّات الفلسطينية. الأبعاد الإنسانية والسياسية لرفض الدعم إن منع مصر لهذه القوافل لم يكن مسألة إجراءات أمنية بحتة؛ بل له تداعيات إنسانية وسياسية مأساوية. إن قطاع غزة اليوم على شفا مجاعة محققة فكثير من الناس يواجهون خطر الموت جوعاً. وقد أكدت منظمات أممية أن نحو نصف سكان القطاع يواجهون «مجاعات محدقة» إن لم يُرَد الحصار والأزمات وهنا تأتي المبادرات الشعبية لإيصال مساعدات وأصوات صرخات المدنيين خارج إطار السياسة؛ فرفضها يعمّق مأساة غزة ويحاسب ضمائرنا. من الجانب السياسي، تكشف سياسات القاهرة الرديفة للموقف الإسرائيلي مخططًا أخطر: إذ تؤكد أن القيادة المصرية تختار مصالحها الاستراتيجية (التنسيق الأمني مع واشنطن وتل أبيب) على حساب التضامن العربي والإنساني. فبحسب شهادات عناصر معنية، كان الهدف الحقيقي لقمع القافلتين ليس حماية مصر بل حماية اتفاقية السلام مع إسرائيل واستمرارها في نهج «حفظ التوازن» بل إنّ التقارير كشفت عن استغلالٍ مادي للمعركة: فقد اتهم قادة فلسطينيون ورجال أعمال مقربون من النظام المصري بفرض «فدية» تصل إلى عشرة آلاف دولار لكل فلسطيني يرغب…