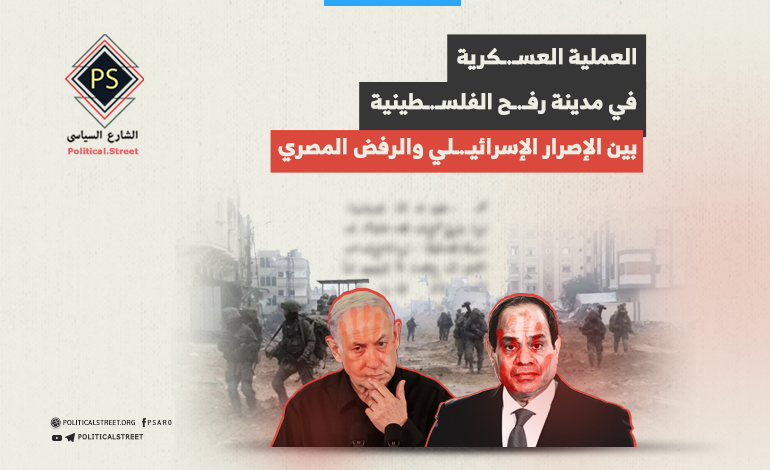الموقف الروسي من العدوان الإسرائيلي علي غزة: الأبعاد والمحددات
تراقب روسيا عن كثب حالة التصعيد التي يشهدها قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي عليه في أعقاب الهجوم الذى نظمته حماس داخل مستوطنات غلاف غزة يوم السابع من أكتوبر 2023 (عملية طوفان الأقصى). إذ فوجئت روسيا كما غيرها من الدول بقوة الهجوم واتساع نطاقه، لكن ومع اتجاه الجانب الإسرائيلي لشن عدوانه على القطاع بدءًا من اليوم الرابع ومحاولاته فرض خطط من شأنها التهجير القسري لسكان القطاع تجاه المناطق الجنوبية منه، أو بدفعهم نحو “وطن بديل” خارج حدود غزة، بدأ الموقف الروسي ينتقل من مرحلة “المراقبة المتأنية” للحدث إلى مرحلة “التفاعل المحسوب” معه، فبدا الموقف الروسي يدين حماس وإسرائيل، لكنه في الوقت نفسه يبدو أكثر ميلًا للأولى، وانعكس هذا الموقف في الإدانة الرسمية من جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووزير الخارجية سيرجى لافروف لنمط معالجة الغرب للحدث وتطوراته[1]. وعليه تسعي هذه الورقة إلي الوقوف علي أبعاد الموقف الروسي من العدوان الإسرائيلي علي غزة، ومحددات هذا الموقف، ومدي تأثير الموقف الروسي علي وقف هذا العدوان. أولًا: أبعاد الموقف الروسي من العدوان الإسرائيلي علي غزة: يمكن الإشارة إلي أبعاد الموقف الروسي من العدوان الإسرائيلي علي غزة كما يلي: 1- التصريحات الرسمية: اتسمت تصريحات المسئولين الروس في بداية الحرب بالترقب والتمهل، وصدر أول التصريحات من نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، في 7 أكتوبر 2023، والذي اكتفى بالقول: “روسيا تجري اتصالات مع إسرائيل وفلسطين ودول عربية، وتدعو أطراف الصراع إلى وقف إطلاق النار، والعودة إلى طاولة المفاوضات”[2]. ثم علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بالقول: “نؤكد موقفنا المبدئي والثابت بأنه لا يمكن بوسائل القوة حل هذا النزاع المستمر منذ 75 عامًا، وفقط يمكن حله حصرًا بالوسائل السياسية والدبلوماسية، ومن خلال إقامة عملية تفاوضية كاملة على الأسس القانونية- الدولية المعروفة، التي تنص على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش بسلام وأمن مع إسرائيل”. وأعتبرت “التصعيد الحالي نتيجة مباشرة للفشل المزمن في الامتثال للقرارات ذات العلاقة الصادرة عن الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، ولقيام الغرب عمليًا بعرقلة عمل – رباعية الشرق الأوسط للوسطاء الدوليين التي تضم روسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة”. ودعت الخارجية الروسية، الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي إلى وقف فوري لإطلاق النار، ونبذ العنف، وممارسة ضبط النفس اللازم، وإقامة عملية تفاوض، بمساعدة المجتمع الدولي، تهدف إلى إقامة سلام شامل ودائم طال انتظاره في الشرق الأوسط[3]. كشفت هذه التصريحات الأولية حرص روسيا علي عدم مهاجمة أيًا من طرفي الصراع (إسرائيل وحماس)، مكتفية بوضع اللوم على الغرب. وربما كان ذلك نابعًا من رغبة روسيا في لعب دور الوساطة، خاصة وأنها تري نفسها وسيطًا فعالًا في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لعدة أسباب، منها؛أنها دولة محايدة نسبيًا ليس لها مصالح مباشرة في الصراع مثل الولايات المتحدة، ولديها علاقات جيدة مع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على حد سواء، ولديها خبرة طويلة في إدارة النزاعات والوساطة في مناطق أخرى مثل سوريا، وترغب في زيادة تأثيرها ودورها الإقليمي وهذا يتطلب النجاح في مهمة التوسط، وأن الإحباط الفلسطيني من دور الوساطة الأمريكية قد يفتح المجال لدور روسي بديل[4]. لكن حالة الترقب بدأت تتلاشى بالتدريج لدى المسؤولين الروس مع تصاعد وتيرة الحرب على غزة، وسقوط المدنيين الفلسطينيين بأعداد كبيرة. فخلال مؤتمر الطاقة الذي عقد في موسكو، في 11 أكتوبر 2023، انتقد الرئيس فلاديمير بوتين ما ينشر عن خطة إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، محملًا سياسة الاستيطان الإسرائيلية المسؤولية، ومعتبرًا أن أحد أسباب ما قامت به حركة حماس يعود إلى هذه السياسة، “فالأرض التي يعيش عليها الفلسطينيون هي تاريخيًا أرضهم”، حيث كان من المفترض إقامة دولة فلسطينية مستقلة[5]. وذهب إلى أبعد من ذلك عندما شبه، في 13 أكتوبر، خلال مؤتمر صحفي في بشكيك عاصمة قرغيزستان، الحصار الذي فرضته إسرائيل على قطاع غزة بحصار ألمانيا النازية لمدينة لينينغراد الروسية خلال الحرب العالمية الثانية. وقال بوتين إن الحصار المحكم الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة الذي يعيش فيه أكثر من مليوني نسمة غير مقبول. محذرًا من أن شن إسرائيل عملية برية في غزة سيؤدي إلى زيادة الخسائر في صفوف المدنيين. وكرر بوتين انتقاداته السابقة للولايات المتحدة، قائلًا إن “المأساة الحالية هي نتيجة لفشل السياسة الأميركية في الشرق الأوسط”[6]. فيما قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مقابلة مع وكالة أنباء بيلاروسيا الرسمية “بيلتا” نشرتها في 28 أكتوبر 2023، إن القصف الإسرائيلي على غزة يتعارض مع القانون الدولي ويخاطر بالتسبب في كارثة يمكن أن تستمر لعقود. وقال لافروف “بينما نندد بالإرهاب، فإننا نرفض بشكل قاطع إمكانية الرد على الإرهاب من خلال انتهاك قواعد القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك الاستخدام العشوائي للقوة ضد أهداف من المعروف أن هناك مدنيين يتواجدون فيها، ومنهم الرهائن المحتجزون”. وأضاف أن من المستحيل القضاء على حماس، مثلما تعهدت إسرائيل، بدون تدمير غزة مع معظم سكانها المدنيين. وتابع “إذا تم تدمير غزة وطرد مليوني نسمة، مثلما يقترح بعض السياسيين في إسرائيل والخارج، فإن ذلك سيؤدي إلى كارثة لعقود عديدة، إن لم يكن لقرون”. وقال “لابد من التوقف والإعلان عن برامج إنسانية لإنقاذ السكان تحت الحصار”[7]. بينما أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، في 22 نوفمبر 2023، أن إسرائيل لم تقدم أي دليل يثبت استخدام حركة حماس للمستشفيات في قطاع غزة لأغراض عسكرية، مضيفًا أن ضرب أهداف مدنية أخرى مثل المساجد، والكنائس، ومخيمات اللاجئين، ومواقع الأمم المتحدة التي يلجأ إليها النساء والأطفال في غزة هربًا من القصف يمثل انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي[8]. كما دعا نيبينزيا، في 27 فبراير 2024، إلى دراسة إمكانية فرض عقوبات من مجلس الأمن الدولي علي إسرائيل بسبب عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة[9]. بالنظر إلي هذه التصريحات الروسية يتضح أن موسكو قد امتنعت عن الإشارة إلى هجوم حماس في السابع من أكتوبر (عملية طوفان الأقصى) باعتباره عملًا “إرهابيًا”، ولم تعتبر موسكو حماس حركة “إرهابية”، بل اعتبرتها منظمة تحرير وطنية (وهذا اعتراف بحماس، وإقرار بحقها)، كما أنها رفضت التعامل مع حماس على أنها كيان منفصل عن الشعب الفلسطيني[10]. ورغم إدانة روسيا لهجوم حماس على المدنيين الإسرائيليين، إلا أنها وجهت اللوم للاحتلال الإسرائيلي على ممارساته، ورده غير المتناسب. كما انتقدت روسيا الدور الغربي لعدم ضغطه على إسرائيل من أجل تحقيق مطلب الدولة الفلسطينية المستقلة[11]، وإعطائه الشرعية لإسرائيل في استمرار عملياتها العسكرية بدون محاسبتها على قتل المدنيين واستهداف المؤسسات في قطاع غزة[12]. 2- الاتصالات الدبلوماسية: بينما سارع قادة الدول الكبرى، وفي طليعتهم رئيس الولايات المتحدة إلى زيارة إسرائيل لإعلان دعم مطلق للعدوان المخطط له علي غزة عقب عملية “طوفان الأقصى”، فإن المسؤولين الروس لم يبادروا إلى اتخاذ خطوة مشابهة[13]. بل إن الرئيس بوتين لم يتصل برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلا بعد مرور عشرة أيام، في…